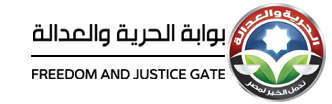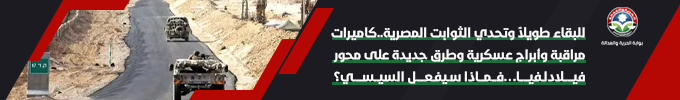فوز كاسح للأحزاب الموالية يعيد إلى الأذهان برلمان مبارك الأخير
كشفت النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المصرية عن مشهد سياسي، يكاد يطابق في بنيته ووظيفته برلمان الحزب الوطني المنحل عام 2010، الذي مثّل الذروة الأخيرة لنظام حسني مبارك قبل اندلاع ثورة 25 يناير، حيث حصدت الأحزاب والقوى المقرّبة من السلطة الحالية غالبية كاسحة من مقاعد مجلس النواب، في غياب شبه كامل لأي معارضة حقيقية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، السبت، نتائج أطول عملية اقتراع في تاريخ الحياة النيابية المصرية، والتي بدأت في 10 نوفمبر واستمرت قرابة شهرين، بعد إلغاء التصويت وإعادته في عشرات الدوائر، بدعوى وجود مخالفات في إجراءات الفرز، وهي ممارسات أعادت إلى الواجهة اتهامات قديمة بتدخل الأجهزة التنفيذية في إدارة العملية الانتخابية.
وبحسب النتائج الرسمية، ثبّت حزب «مستقبل وطن»، المحسوب على السلطة، موقعه كأكبر كتلة ممثلة في البرلمان بنظام الترشح الفردي، يليه حزب «حماة الوطن»، بينما حصلت الأحزاب الثلاثة المؤيدة للنظام — مستقبل وطن، وحماة الوطن، والجبهة الوطنية — مجتمعة على نحو 164 مقعداً من أصل 596، بنسبة تقارب 27%، في حين ذهبت غالبية المقاعد المتبقية إلى أحزاب صغيرة ومرشحين مستقلين، لا يخرجون بدورهم عن الفلك السياسي للنظام.
وسجلت الانتخابات نسبة مشاركة بلغت 32% فقط من إجمالي من يحق لهم التصويت، وهي نسبة تعكس ــ وفق مراقبين ــ حالة العزوف الشعبي وفقدان الثقة في جدوى المسار الانتخابي، في ظل غياب المنافسة الفعلية واستبعاد الأصوات المعارضة.
ويُدار البرلمان المصري عبر خليط من القوائم المغلقة والفردي، إلى جانب تعيين رئيس الجمهورية 5% من الأعضاء، مع تخصيص 25% من المقاعد للنساء وفق نص الدستور، غير أن نظام القوائم المغلقة كان العامل الأبرز في إحكام السيطرة السياسية، إذ لم تتقدم سوى قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر»، التي اكتسحت الانتخابات دون منافسة تُذكر، كما فعلت سابقاً في انتخابات مجلس الشيوخ.
وتقود هذه القائمة مجموعة من 12 حزباً، على رأسها «مستقبل وطن»، إلى جانب حزب «الجبهة الوطنية» الذي تأسس حديثاً برئاسة الوزير السابق عصام الجزار، وبدعم مباشر من رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، المقرّب من المنقلب عبد الفتاح السيسي، في مشهد يعيد إلى الأذهان الدور الذي لعبه أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني، في هندسة برلمان 2010 لصالح مشروع التوريث آنذاك.
ويرى محللون أن خطورة هذا البرلمان لا تكمن فقط في طبيعته أحادية الصوت، بل في توقيته السياسي، إذ يُعدّ الأخير قبل انتهاء الولاية الثالثة للسيسي عام 2030، وهي الولاية التي يُفترض دستورياً أن تكون الأخيرة، ما يمنح البرلمان المنبثق عنه دوراً محورياً في حال قرر السيسي الدفع نحو تعديل دستوري جديد لإطالة أمد حكمه، كما حدث في تعديلات 2019 التي مددت فترة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات.
ويأتي هذا المشهد السياسي في ظل انتقادات حقوقية متصاعدة للنظام المصري، بسبب التضييق على الحريات العامة وحرية التعبير، واستمرار حبس المعارضين، رغم إطلاق ما سُمّي بـ«الحوار الوطني» عام 2022، الذي لم ينعكس، حتى الآن، على الواقع السياسي أو الحقوقي.
وفي وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خانقة، وديون متفاقمة، تعتمد الحكومة على صفقات استثمارية مع دول الخليج وقروض من صندوق النقد الدولي، بينما يُعاد إنتاج برلمان منزوع السياسة، يعكس، في نظر كثيرين، إصرار النظام على تكرار أخطاء نظام مبارك، التي انتهت بانفجار شعبي غيّر وجه مصر قبل أكثر من عقد.